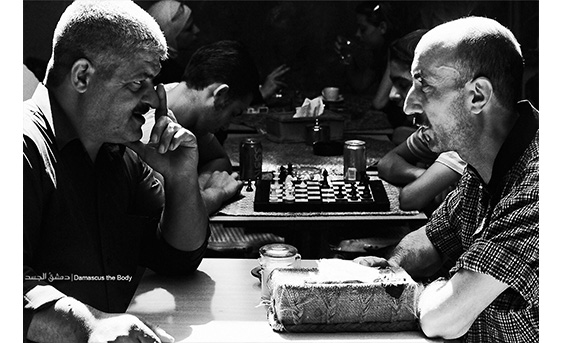حسام الدين درويش
يمثل “الإرهاب” (إرهاب الأنظمة الحاكمة بالدرجة الأولى، وإرهاب التنظيمات “المتطرفة” الناتجة عن الإرهاب الأول، بالدرجة الثانية) القائم والمستمر في البلدان الأساسية المصدِّرة للموجة الأخيرة من اللاجئين، أحد أهم العوامل التي “أجبرت ملايينَ من البشر على مغادرة مدنهم وقراهم وبلدهم، والبحث عن ملاذٍ آمنٍ وحياةٍ معقولةٍ في بلادٍ أخرى.
لكن معاناة هؤلاء اللاجئين من الإرهاب لا تنتهي، حتى وهم بعيدون عن مكان حصوله، و/أو غير معرضين لأي خطرٍ مباشرٍ بسببه. فمعظم اللاجئين يتابعون أخبار هذا “الإرهاب” المستمر، بكثيرٍ من الحزن والغضب والجزع، لا لأنه من “الطبيعي” و”الإنساني” أن يثير هذا الإرهاب كل هذه المشاعر المنددة بمقترفي الإرهاب والمتعاطفة مع ضحاياه فحسب، ولا لأن هذا الإرهاب يقضي على أي أملٍ بإمكانية تحسن الأحوال في بلدهم بما يمهد للعودة المأمولة إليه، في المدى المنظور، فقط، بل، أيضًا وخصوصًا، لأن معظم اللاجئين يخشون على ما تبقى من بلدهم وعلى حياة أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم الذين ما زالوا مقيمين في تلك البلاد المنكوبة بالإرهاب.
للأسف الشديد، لا يقتصر تأثر اللاجئين بالإرهاب على ما سبق. فعند تعرض أي بلدٍ مستضيفٍ للاجئين لحدثٍ “إرهابيٍّ” ما، يمسك معظم اللاجئين بقلوبهم، ويسود الحزن والغضب والخوف معظم أوساطهم. لكن هذه المشاعر ليست غالبًا مماثلة لمشاعر الإنسان أو المواطن “العادي”، إذ لا يكون التعاطف مع الضحايا والتنديد بالإرهابيين هو ردة فعلهم النفسية والأخلاقية وحتى الفكرية الأولى من حيث الزمان أو الأهمية. فالهم الأوَّل والأهم لديهم حينها هو ألا يكون “الإرهابي” منهم (كما يتوقعون أو يتخوفون غالبًا) بمعنى أن يكون “الإرهابي” لاجئًا و/أو مسلمًا مثلًا وخصوصًا. وفي بوست فيسبوكي، عبرت السيدة دينا أبو الحسن عن ردة الفعل الأساسية لدى اللاجئين بقولها: “يا رب يكون نازي يا رب يكون نازي يا رب يكون نازي. دعاء جماعي لكذا مليون إنسان الليلة.”
إن استثنائية وضع اللاجئين تجعلهم في وضعٍ دفاعيٍّ وأنانيٍّ، عند حصول أي هجومٍ إرهابيٍّ في البلدان التي يقيمون فيها أو في البلدان المجاورة لها.
فهم يتخذون الوضع الدفاعي من خلال التشديد على أن الإرهابيين لا يمثلونهم ولا يمثلون معتقداتهم، ولا يعبرون عن توجهاتهم وأفكارهم وانتماءاتهم. ويتسم موقفهم بالأنانية، بقدر ما يكون متمحورًا حول مصالحهم والنتائج السلبية التي قد تترتب عليهم، نتيجةً لهذا الهجوم، بدلاً من أن يتأسس، بالدرجة الأولى، على الحزن على الضحايا والغضب من “الإرهابيين”، كما يُفترض أن يحصل لدى الإنسان “العادي”. ويمكن لهذه الدفاعية وتلك الأنانية أن تثيرا الكثير من مشاعر الاستغراب والاستهجان والغضب … إلخ، لكن ينبغي لهذه المشاعر أن تترافق مع محاولةٍ لفهم موقف هؤلاء اللاجئين ومعرفة أسبابه التي يمكن أن تكون مسوِّغةً أو حتى مبرِرةً له، لدرجةٍ أو لأخرى.
السؤال الأساسي إذن: لما لا يكون، أو من الصعب أن يكون، اللاجئ إنسانًا “عاديًّا”، في ردة فعله على الحوادث الإرهابية التي تقع في البلاد المستقبلة للاجئين؟ لا يمكن بالطبع الإجابة عن هذا السؤال ببساطةٍ مبسِّطةٍ، لكن يمكن القول مبدئيًّا إن جزءًا أساسيًّا من الإجابة يكمن في نقطتين رئيسيتين مترابطتين: هشاشة وضعهم (في بلدان اللجوء)، والصورة النمطية السلبية عنهم.
إن وضع اللاجئين هشٌّ من نواحٍ عديدةٍ (قانونيةٍ، اقتصاديةٍ، اجتماعيةٍ، نفسيةٍ … إلخ). فعلى الصعيد القانوني مثلاً، يرتبط مصير اللاجئين، ومصير أسرهم في بلدان اللجوء، بقرارات منحهم أو عدم منحهم الإقامة، ومدة هذه الإقامة، ونوعها… إلخ.
ويمكن لأي حدثٍ إرهابيٍّ أو لأية اضطراباتٍ أو تغيراتٍ سياسيةٍ أن تفضي إلى تغييرٍ سلبيٍّ كبير في وضعهم. فمن المعروف المعاناة الكبيرة التي عاشها معظم اللاجئين السوريين في مصر بعد انقلاب السيسي. وكان هناك تخوفٌ كبيرٌ من تعرض اللاجئين السوريين في تركيا لمعاناةٍ أكبر ونتائج بالغة السلبية، في حال نجاح الانقلاب في تركيا. ومن جانبٍ معيَّنٍ، لا يختلف الأمر كثيرًا في أوروبا “الغربية” والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترتفع أصوات اليمين وترتفع شعبيتهم بعد كلِّ حدثٍ “إرهابيٍّ”، ويهيمن منطق “ما قلنالكم؟!” على الساحة: “ما قلنالكم إن هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين يشكلون خطرًا على مجتمعنا وديمقراطيتنا؟، “ما قلنالكم إنه ينبغي عدم استقبال هؤلاء اللاجئين أو ترحيلهم أو طردهم؟”، “ما قلنالكم إن اندماجهم مستحيل وخطرهم أكيد؟”، … إلخ. ونتيجة للشيوع الجزئي والنسبي لهذا الخطاب وزيادة قوته وشعبيته، يتم اللجوء إلى تشديد إجراءات اللجوء، وتخفت الأصوات الرسمية وغير الرسمية للثقافة المرحبة، ويتم الخضوع لمنطقه وأهدافه، بدون الاعتراف بهذا الخضوع. يكلِّف هذا الخضوع، أو يمكن أن يكلِّف، اللاجئين ما لاطاقة لهم على تحمله، لا اقتصاديًّا ولا نفسيًّا. فليس لدى معظم اللاجئين القدرة الاقتصادية على تغيير مكان إقامتهم الحالي ومحاولة البدء من جديدٍ في مكانٍ آخر. كما أن معظمهم متعبٌ ومستنفدٌ نفسيًّا، لدرجةٍ تجعله يتوخى الهدوء والاستقرار “بأي ثمنٍ” تقريبًا. لهذه الأسباب تطغى السمة الواقعية أو البراغماتية، لا الأخلاقية أو الإنسانية “المثالية”، على ردات فعل الكثير من اللاجئين تجاه الأحداث التي يمكن أن تفضي إلى تشكيلٍ خطرٍ عليهم. فمعظم اللاجئين، على الأقل، هم ضحايا لإرهابٍ مباشرٍ تعرضوا له أو كانوا مهددين بالتعرض له في بلدانهم. ولهذا يكون همهم الأول في بلدان اللجوء ألا يكونوا، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، ضحايا إرهابٍ جديدٍ. وهذه الإمكانية لأن يكونوا ضحايا مجدّدًا هي التي تمنع التعاطف مع الضحايا الجدد من أن يكون سائدًا أو مهيمنًا في ردة فعلهم الأولية على الأقل.
ترتبط هشاشة وضع اللاجئين بالصورة النمطية السلبية عنهم، وبتضخيمهم، هم أنفسهم، لهذه الصورة السلبية، بل وبتبنيها أحيانًا أو غالبًا، أيضًا.
فمن ناحيةٍ أولى، ثمة خطابٌ في بلدان اللجوء الأوروبية يرى أن معظم اللاجئين “متخلفين” و”غير حضاريين” وأن ثقافتهم ودينهم مرتبطان بالعنف والإرهاب وما شابه. فعندما تسمع عن وجود قسم لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الألمانية، فإنك لن تتفاجأ كثيرًا عندما تعلم أن التطرف الوحيد المقصود هنا هو التطرف المرتبط بالإسلام والإسلاميين أو الإسلامويين. وعندما يكون المجرم المسمى إرهابيًّا مسلمًا بمعنى ما، يتم ربط إجرامه أو إرهابه بدينه أو بانتمائه الديني الفعلي أو المفترض، بطريقةٍ أو بأخرى (حتى لو كان الشخص غير متديِّنٍ ولا علاقة مباشرة بين فعله الإجرامي وعقيدته الدينية المفترضة)، وهو أمرٌ لا يحصل في حال كان ذلك الإرهابي غير مسلمٍ. وبغض النظر عن مدى مصداقية أو عدم مصداقية هذه الصورة النمطية السلبية، فينبغي ملاحظة أمرين أساسيين، أولهما، على العكس مما هو رائجٌ في الثقافة السائدة في البلدان المصدرة للاجئين، إن قسمًا لا يستهان به من الشعوب “الغربية” لا يتبنى هذه الصورة النمطية، وثانيهما إن شيوع هذه النظرة للاجئين، بين اللاجئين أنفسهم أكبر بكثير من شيوعها لدى شعوب الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين (ألمانيا مثلاً وخصوصًا). وفي ردة فعل اللاجئين على حدث “إرهابيٍّ” ما في بلدان اللجوء، تسود ردة فعل دفاعية ضد النظرة الدونية أو الصورة النمطية السلبية التي يفترضون أن الأوروبيين يتبنونها، والتي يتبناها، جزئيًّا ونسبيًّا، قسمٌ لا يستهان به من اللاجئين أنفسهم. فينشغل الكثير منهم، أو بالأحرى منا، بالقول: “لسنا إرهابيين فعليين أو محتملين”، و”الإرهاب لا علاقة بالإسلام”، “لسنا متخلفين أو سيئين كما أو بالدرجة التي تعتقدون”. ويبدو لي غالبًا أن هذا النفي يعبر عن توكيد واعتقاد معاكس له تمامًا.
إن هشاشة وضع اللاجئين وتبني الصورة النمطية السلبية عنهم، يجعلهم غالبًا في موقع ردة الفعل المسبقة الصنع، لا المنفعلة بالمستجدات والفاعلة وفقًا لها. لكن ذلك ليس قدرًا لا فكاك منه.
وبعيدًا عن ردات الفعل الدفاعية التي تتحول أحيانًا إلى هجوميةٍ عدوانيةٍ (“أنتم المجرمون، لا نحن!”، “أنتم منبع الإرهاب، لا نحن!”، وردات الفعل الأنانية (“المهم أو الأهم هو ألا يكون المجرم محسوبًا علينا!”)، أرى ضرورة السعي إلى تبني ردات فعلٍ أكثر أخلاقيةً وإنسانيةً. صحيحٌ أن الإنسان لا يتحكم بمشاعره، لكن من الصحيح أيضًا أن العواطف والمشاعر يمكن أن تكون ترسبًا لأفكارٍ، ونتيجةً للاقتناع بها. والعامل الذاتي لا يكفي بالتأكيد، فثمة ضرورة لحصول تغير في الشروط الموضوعية المتعلقة بوضع اللاجئين الهش. لكن عدم كفاية العامل الذاتي لا ينفي أهميته وضرورته. وسعينا إلى أن نكون، في ردات فعلنا، بل وفي فعلنا، ناسًا “عاديين و”طبيعيين”، هو شرطٌ ضروريٌ لاستعادة إنسايتنا المسلوبة نتيجةً لمسببات اللجوء وظروفه ونتائجه. وفي هذا السعي وهذا الشرط يكمن، من وجهة نظري، “أرقى” معنىً ممكنٍ، لمصطلح “الاندماج”.
*كاتب وباحث سوري.
مقالات ذات صلة
“من هم، وكم عدد اللاجئين الذين ينبغي لنا استقبالهم؟”